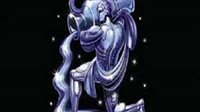الدكتور محمد حمزة يكتب: "ألقاب بلا أثر... حين تغيب المعايير وتُختزل الحضارات"

ما أشبه الليلة بالبارحة! نحن نعيش في زمن طغت فيه الألقاب على الإنجاز، وتزايدت فيه المناصب القيادية والجوائز والعضويات في اللجان والمجالس بمختلف تخصصاتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. ورغم هذا الزخم، تبقى النتائج الملموسة على أرض الواقع شبه معدومة.
مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، دورات تدريبية، ملتقيات، رسائل ماجستير ودكتوراه، مناقشات وترقيات... لكن هل ترك كل هذا أثرًا حقيقيًا في تطور البحث العلمي؟ وهل انعكس ذلك على خدمة المجتمع أو تلبية احتياجات سوق العمل؟
وتبقى الأسئلة الكبرى: من يُشكّل اللجان؟ ما هي معايير اختيار المحكّمين؟ وهل تمت مراعاة التخصصات الدقيقة في التقييم؟ الجميع يعلم، لكن الصمت هو السائد، وكأن الأمور تسير بلا مراجعة أو مساءلة.
والنتيجة؟ نجد أنفسنا أمام عدد لا يُحصى من الأساتذة، دون إنتاج علمي ملموس أو تأثير واضح. في الماضي، كان مجرد ذكر اسم أستاذ يثير التقدير، ويستدعي تلقائيًا قوائم مؤلفاته وبحوثه رغم أننا لم نلتقِ به. أما اليوم، فكثيرون يحملون لقب "أستاذ"، دون أن نعرف لهم نتاجًا علميًا واضحًا... ومع ذلك يقول أحدهم: "أنا أستاذ كذا!"... يا للعجب!
نعيش اليوم واقعًا مثيرًا للتساؤل، حيث نُقابل من يحملون ألقابًا أكاديمية مرموقة، دون أن يكون لهم إنتاج علمي معروف أو إسهام يُذكر في مجالاتهم، ومع ذلك يُقال عنهم "أستاذ كذا!"... يا للعجب.
وعندما نتساءل عن المحصلة الحقيقية على أرض الواقع، لا نجد شيئًا يُذكر. فرغم وفرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعدد المنصات الرقمية من فيسبوك ويوتيوب إلى تيك توك وبودكاست وغيرها، إلا أن النتائج ضئيلة. نحن في عصر العولمة والانفتاح، عصر الاتصال والتشارك والحرية المعلوماتية، ومع ذلك نشهد تكرارًا وتسطيحًا، بل وتضليلًا وتشكيكًا، في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.
أين المعايير؟ أين أدوات الرقابة والمتابعة؟ كيف يُتّخذ القرار؟ هل يُعتمد على الكفاءة والخبرة، أم على الولاء والثقة فقط؟
على مدار سبعة عقود، برزت شخصيات تم تعيينها في مناصب قيادية داخلية وخارجية فجأة، دون أن يكون لها دور سابق معروف أو سيرة ذاتية قوية تُبرّر ذلك. ثم ما إن يغادروا هذه المناصب، حتى يغيب أثرهم، فينطبق عليهم قول القائل: "وبادوا جميعًا، فلا مخبر عنهم".
الغريب أن نفس الأسماء تُستدعى مرة بعد أخرى، وتتنقّل بين المجالس العليا، واللجان الاستشارية، والنيابية، والإدارية، وتحصد الجوائز والتكريمات... ولا نعلم لماذا، ولا نرى ما قدّموه من إنجازات أو طفرات حقيقية مثل ما فعل روّاد كأحمد زويل أو مجدي يعقوب.
ومع أن مصر ولّادة، وتزخر بالكفاءات، إلا أن الإعلام يُعيد إنتاج نفس الوجوه، بل ويستعين بمن لا يملك التخصص أو المعرفة الدقيقة بما يتحدث عنه، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التشكيك في الرموز وزعزعة الثوابت والهوية الوطنية.
عجبي... كما قال صلاح جاهين في رباعياته.
من المفارقات المؤلمة أن بعض الأشخاص ممن يُقدَّمون كرموز للنجاح والمؤسسات، باتت إنجازاتهم تُقاس بمدى انتشار صورهم اليومية عبر المنصات المختلفة: في الاجتماعات، على السلالم، عند أبواب المكاتب، أو أثناء ركوب السيارات، وكل ذلك يتم بواسطة موظفين متخصصين أو عبر فرق العلاقات العامة. فهل أصبح "ركوب التريند" وملء الصفحات بالصور هو الإنجاز؟ وأين هي الطفرة الحقيقية أو النقلة النوعية لتلك المؤسسات؟ إلى متى يستمر هذا العبث والاستخفاف؟
والأدهى أنه حين يترك أحدهم منصبه، يُعيّن فجأة رئيسًا للجنة أو عميدًا لأحد أقسام الكليات، رغم اقترابه من سن التقاعد، ومع أن الوزارة ذاتها ليست بحاجة إلى خريجي هذا التخصص، بل لا توجد حتى تعيينات! والغريب أن هذا المجال تحديدًا تم التوسع فيه، فاستُحدثت له كليات عديدة، بات فيها عدد أعضاء هيئة التدريس أكبر من عدد الطلاب أنفسهم! فأين هي الرؤية؟ وأين دراسات احتياجات سوق العمل؟ وأين الأجهزة الرقابية؟
لسنا ضد اختيار أهل الثقة، ولا نستنكر حصد الأوسمة والجوائز، فهذه أمور لا تشغلنا بذاتها. ما يشغلنا، ويدفعنا للتساؤل، هو غياب المعايير الموضوعية، وانتشار الفساد والمحسوبية والمجاملات، كما حدث خلال العصر المملوكي، حين أصبح البذل والبرطلة معيارًا للمكانة، وتراجعت القيم والأخلاق، مما أدى إلى تفشي الرذائل والأمراض الاجتماعية.
والنتيجة؟ الانهيار الحتمي. وهذا ما تؤكده شواهد التاريخ عبر حضارات عديدة، أبرزها مدينة "بومبي" الإيطالية التي دهمها بركان فيزوف عام 79م، وقد يكفي مجرد زيارة لأطلالها لفهم كيف تسبّب الترف المفرط وانعدام الانضباط في فنائها.
وبالنسبة للتاريخ الإسلامي، فالعالم الإسلامي شهد بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة 422هـ/1031م، انهيارًا وتفككًا إلى دويلات وإمارات عرفت بملوك الطوائف، حتى بلغ عددها 22، حيث تصدّر مشهدها ألقاب لا تعكس الجوهر، تمامًا كما وصف الشاعر:
مما يزهدني في أرض أندلس
أسماء مقتدر فيها ومعتضد
ألقاب مملكة في غير موضعها
كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد
فهي حالة تكررت عبر التاريخ... وتبدو اليوم وكأنها تعود إلينا بشكل جديد، على هيئة صور ومنشورات ومقاعد بلا أثر.
لطالما حمل بعض القادة والأمراء ألقابًا ضخمة توحي بالقوة والسيادة والعظمة، بينما كان واقعهم يعكس الضعف والتخاذل، وأداءهم لا يرتقي إلى ما توحي به أسماؤهم. فإلى جانب التحالفات المتضاربة والصراعات الداخلية، بلغ الأمر ببعضهم حد الاستقواء بالقوى المسيحية المجاورة لتثبيت عروشهم، مما ساهم في تشظي الأندلس وتدهور حالها.
وقد بدأت حركة الاسترداد بسقوط مدينة طليطلة عام 478هـ/1085م على يد ألفونسو السادس، وما لبثت المدن والقواعد الأندلسية أن سقطت تباعًا، حتى انهارت آخرها—غرناطة عاصمة بني نصر—عام 897هـ/1492م، لتنتهي بذلك ثمانية قرون من الحضور الإسلامي في الأندلس.
فما أشبه الليلة بالبارحة! إذ يبلغ عدد الدول العربية في قارتي آسيا وإفريقيا اليوم 22 دولة، وهو نفس عدد دويلات ملوك الطوائف... صدفة تحمل في طيّاتها الكثير من الدلالات. وما يحدث اليوم في فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص، ليس بعيدًا عن السياق التاريخي ذاته، ولكنه حديثٌ يحتاج مساحة خاصة.
يا سادة، المسألة ليست ألقابًا ومناصب وعضويات في لجان ومجالس وجمعيات، ولا جوائز ولا تنقلات بين مؤسسات متعددة. فما الجدوى إن ظلّ الواقع متجمّدًا، والمحصلة لا شيء؟ نحن بحاجة إلى أن نكون على قدر هويتنا المصرية، وعلى مستوى مسؤوليتنا تجاه العالم من حولنا، وفي مستوى العصر الذي نعيشه. ولن يتحقق هذا بالألقاب والمناصب، بل بالعلم والعمل، وبالأمانة والرؤية والاستراتيجية المبنية على التحليل الرباعي العالمي.
وهذا ما يؤكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة: أننا بحاجة إلى كفاءات ومهارات وخبرات حقيقية، تعمل وفق معايير موضوعية وتخضع للمتابعة والرقابة.
فلله در القائل:
فمن كان ذا عبرة فليكن
فطينًا، ففي مَن مضى معتبر
إذن، جوهر العملية ليس الألقاب ولا المجالس ولا التدوير ولا الجوائز... بل هو العلم، والعمل، والإيمان، والهوية، والخبرة، والكفاءة، والمعايير، والرؤية، والخطة، والمتابعة الدقيقة. والأهم من ذلك كله: أن ينعكس هذا في واقع ملموس، في حياة الناس، في نهضة المجتمع، وفي تحسين حقيقي يُرى ويُحس.